دكتــــــــــــــــــــــــور حسن نافعة يكتب ازمة القيادة السياسية -1 مصــــــــــــــــــــر الى اين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مصــــــــــــــــــــر الى اين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يتابع العالم العربي ما يجري في مصر باهتمام، تحول في الآونة الأخيرة إلى قلق حقيقي لسببين، الأول: يعود إلى إدراك متزايد بأن أوضاع العالم العربي ككل تزداد ترديا يوما بعد يوم، وبأن وقف هذا التردي بات مرهونا بحدوث تغيير جوهري في توجهات السياسة المصرية الراهنة، والثاني: يعود إلى إدراك متزايد بأن احتمالات التغيير السلمي المنشود في مصر تتضاءل يوما بعد يوم وعلى نحو ينذر بوقوع كارثة كبرى، يخشى أن تطال الجميع. عمّق من هذا القلق في وعي النخب العربية مشهدان بثتهما الفضائيات في الآونة الأخيرة، وفي وقت متزامن تقريبا،
الأول: مشهد تزاحم المواطنين إلى حد الاقتتال، للحصول على رغيف خبز في طوابير تبدو بلا نهاية، والثاني: مشهد طوابير من نوع آخر يقف فيها أناس أمام لجان الترشيح للانتخابات المحلية، تبين فيما بعد أنهم موظفون، حشدهم الأمن لعرقلة أو منع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من تقديم أوراق ترشحهم. وبينما دلّ المشهد الأول على تفاقم واستحكام الأزمة الاقتصادية، خاصة أزمة المعيشة التي تعاني منها الأغلبية الساحقة في مصر، دلّ المشهد الثاني على تفاقم واستحكام الأزمة السياسية وانسداد أفق الإصلاح وتلاشي آمال التحول الديمقراطي بالوسائل السلمية، وهو ما رسخه مؤخرا مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين..
ولأن أحدا لا يملك في الوقت الراهن إجابة واضحة ودقيقة عن سؤال: مصر إلى أين؟، فمن الطبيعي أن تتعدد الاجتهادات، حسب زوايا الرؤية. غير أن أي محاولة للإجابة عن هذا السؤال تتطلب أولا، وفي جميع الأحوال، فهم الأسباب التي أدت إلى وصول الأوضاع في مصر إلى ما هي عليه الآن.
للأزمة الراهنة في مصر أسباب عميقة الجذور، أهمها في تقديري:
1- أزمة قيادة سياسية، تباينت أنماطها إلى حد التناقض منذ عام 52 حتى الآن. 2- فشل إدارة عملية الانتقال من الحزب الواحد إلى التعددية السياسية. 3- ضعف قوى المعارضة وعجزها عن طرح بديل للتحول السلمي نحو الديمقراطية، وسوف نناقش هذه العوامل تباعا في هذه السلسلة من المقالات.
فقد تعاقب على حكم مصر منذ منتصف القرن الماضي - إذا استثنينا محمد نجيب- ثلاثة زعماء ينتمي كل منهم إلى نمط مختلف تماما من أنماط القيادة: النمط الثوري، ومثّله جمال عبدالناصر، والنمط المغامر، ومثّله أنور السادات، والنمط البيروقراطي ومثّله حسني مبارك، ورغم التباين الهائل في السمات الشخصية والتوجهات العقائدية لهذه الأنماط الثلاثة، وما ترتب عليه من تباين مماثل في السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها كل منهم، فإن النظام السياسي، الذي استحدثته ثورة 1952، بقي دون تغيير يذكر، وهو عامل ربما يفسر وجود سمات وقواسم كثيرة مشتركة بين هذه القيادات، يمكن في تقديري، إجمال أهمها على النحو التالي:
السمة الأولى: انتفاء الرغبة في التخلي طواعية عن السلطة، فالرئيس عبدالناصر تخلى عن السلطة بالموت الطبيعي، والرئيس السادات أجبر على تركها بالاغتيال، أما الرئيس مبارك - أمد الله في عمره- فلا يزال يمارسها، وسبق له أن أفصح صراحة عن نيته في البقاء فيها طالما ظل في جسده عرق ينبض!
السمة الثانية: تركة ثقيلة تورثها القيادة السابقة للقيادة اللاحقة، فالرئيس عبد الناصر رحل وسيناء لا تزال محتلة وجرح هزيمة 67 لا يزال مفتوحا لم يندمل بعد، والرئيس السادات رحل في ظل حالة من الاحتقان الداخلي والقطيعة مع العالم العربي، لم تشهد مصر لهما مثيلا في تاريخها. ورغم صعوبة التكهن بما ستكون عليه أحوال مصر عند انتقال السلطة إلى خليفة الرئيس مبارك، فإن المؤشرات المتاحة لا تبشر بأي خير.
السمة الثالثة: عدم مشاركة الشعب في اختيار أي من هذه القيادات الثلاث. فالرئيس عبدالناصر وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري. صحيح أن الانقلاب تحول بسرعة إلى ثورة أيدها الشعب، وصحيح أيضا أن عبدالناصر تمتع بشعبية طاغية بدت واضحة، حتى وهو مهزوم، وعبر عنها رفض الشعب المصري تنحي زعيمه بعد هزيمة يونيو، ثم خروجه عن بكرة أبيه لوداعه في جنازته، غير أن عبدالناصر لم يخض أبدا تجربة انتخابات، نافسه فيها أحد، أما السادات فقد جاء باختيار من عبدالناصر، ولأسباب لا يعلمها إلا الله وحده، وكذلك الحال بالنسبة لمبارك، الذي اختاره السادات وحده ولأسباب لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده أيضا، أما الاستفتاءات التي تمت فأقل ما يقال فيها إنها كانت شكلية ونتائجها غير صحيحة، بل مفبركة من الأساس. ويقال الآن إن مبارك أصبح بعد تعديل المادة 76 من الدستور أول رئيس جمهورية في تاريخ مصر ينتخب من بين أكثر من مرشح، إلا أن الكل يعلم أن هذه الانتخابات كانت شكلية وأقرب ما تكون إلى «زفة دعائية إعلامية» لا تليق بشعب عريق كالشعب المصري.
السمة الرابعة: انطلاق آمال عريضة في التغيير مع بداية ولاية كل رئيس، ما تلبث أن تخفت تدريجيا إلى أن تتلاشى تماما مع تحول الحاكم القادم إلى فرعون جديد، على طريقته، بعدها تبدأ حالة من السخط العام تتصاعد تدريجيا إلى أن تصل ذروتها في نهاية كل حقبة.
فخلال فترة زمنية لم تتجاوز سبع سنوات، كان عبدالناصر قد أنجز إصلاحا زراعيا واسع النطاق، وحقق مطلبي الاستقلال والجلاء بإنهاء الاحتلال البريطاني لمصر، وأمم قناة السويس، وبدأ بناء السد العالي، وأقام وحدة اندماجية مع سوريا، لكن النكسات ما لبثت أن توالت بعد ذلك تباعا: انفصال سوريا عن مصر، اندلاع حرب عربية - عربية على أرض اليمن، هزيمة 67 إلخ. أما السادات فحقق إنجازا عسكريا مهما بعد ثلاث سنوات فقط من توليه السلطة، ثم شرع في عملية انفتاح سياسي واقتصادي، بدت واعدة في البداية، لكنه رحل مخلفا وراءه تركة ثقيلة جدا، بدأت مع تنامي ظاهرة العنف والتطرف الديني وانتهت بانتكاسة لعملية الإصلاح السياسي، مع دخوله، بزيارة القدس، في مغامرة غير مأمونة العواقب، أدت إلى عزل مصر عن عمقها الطبيعي وإضعاف دورها ورهن إرادتها.
وفي سنوات حكمه الأولى، استطاع الرئيس مبارك تخفيف حدة احتقان سياسي كانت قد جسدته أحداث سبتمبر 1981، كما استطاع احتواء ظاهرة العنف والتطرف الديني، وإعادة جامعة الدول العربية إلى مقرها في القاهرة والشروع في ترميم البنية التحتية، وعندما استقرت له الأوضاع بمرور الوقت، لم يعد نظامه منهمكا بشيء قدر اهتمامه بالمحافظة على بقائه هو، دون أي اعتبار آخر، وهنا بدأت تتشكل بؤر فساد، ما لبثت أن اتسعت تدريجيا إلى أن تسببت في خلق حالة غير مسبوقة من الاستقطاب الاجتماعي بين قلة تزايد ثراؤها بشكل فاحش وغير مبرر، وأغلبية كاسحة تزايد بؤسها بشكل ظالم ووحشي، وتواكب ذلك مع تدهور عام في مستوى الخدمات من تعليم وصحة ومواصلات وغيرها، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من: فوضى ونذر مجاعة وانسداد أفق التغيير والإصلاح.
غير أن هذا التشابه الظاهري في أداء النظام السياسي المصري يجب ألا يخفي عمق الاختلافات في الرؤى والسياسات المتبعة في كل مرحلة. فقد كان لعبدالناصر والسادات، بحكم تكوينهما الشخصي وتاريخهما النضالي، رؤية سياسية واضحة، افتقدها الرئيس مبارك تماما.
صحيح أن رؤية السادات تناقضت كليا تقريبا مع رؤية عبدالناصر، لكن كلتا الرؤيتين استندت إلى قواعد سياسية واجتماعية، وبالتالي أيديولوجية واضحة ومحددة. وبينما عبرت إحدى الرؤيتين، إجمالا، عن أطروحات اليسار المصري ومصالح الطبقة الوسطى والطبقات الكادحة، عبرت الرؤية الأخرى عن أطروحات اليمين ومصالح طبقة التجار ورجال الأعمال. أما الرئيس مبارك، فبالإضافة إلى افتقاده أي رؤية سياسية، اختلف عن سلفيه في أمرين آخرين على جانب كبير من الأهمية:
أولهما: إدارة الدولة بمنطق التسيير الذاتي اليومي والبيروقراطي، مع تركيز اهتمامه فقط على كل ما من شأنه أن يشكل تحديا لسلطته أو لإرادته كحاكم، ونجاحه المذهل في هذه السياسة، لدرجة أنه تمكن من الاحتفاظ بالسلطة فترة توازي - حتى الآن فقط- مجموع سنوات حكم عبدالناصر والسادات معا.
وثانيهما: رفض تعيين نائب له، مع السماح في الوقت نفسه لنجله جمال بلعب دور سياسي، راح يتنامى بسرعة إلى أن استقر في الضمير العام، خطأ أو صوابا، أن هناك عملية سرية مخططة تجري لإعداده لتولي السلطة في الوقت المناسب، دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بسقف زمني أو بسيناريو محدد لكيفية نقل السلطة، شريطة ألا يبدو «توريثا» بالمعنى المتعارف عليه!
بعبارة أخرى يمكن القول إن رؤساء مصر الثلاثة بدأوا دائما فترات حكمهم بطرح برنامج للتغيير، كان الشعب يأمل أن يفضي في نهاية المطاف إلى إرساء قواعد لنظام ديمقراطي حقيقي، وانتهى في كل مرة - وللأسف الشديد- بتعبيد الطريق أمام فرعون من نوع جديد
 مصــــــــــــــــــــر الى اين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مصــــــــــــــــــــر الى اين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يتابع العالم العربي ما يجري في مصر باهتمام، تحول في الآونة الأخيرة إلى قلق حقيقي لسببين، الأول: يعود إلى إدراك متزايد بأن أوضاع العالم العربي ككل تزداد ترديا يوما بعد يوم، وبأن وقف هذا التردي بات مرهونا بحدوث تغيير جوهري في توجهات السياسة المصرية الراهنة، والثاني: يعود إلى إدراك متزايد بأن احتمالات التغيير السلمي المنشود في مصر تتضاءل يوما بعد يوم وعلى نحو ينذر بوقوع كارثة كبرى، يخشى أن تطال الجميع. عمّق من هذا القلق في وعي النخب العربية مشهدان بثتهما الفضائيات في الآونة الأخيرة، وفي وقت متزامن تقريبا،
الأول: مشهد تزاحم المواطنين إلى حد الاقتتال، للحصول على رغيف خبز في طوابير تبدو بلا نهاية، والثاني: مشهد طوابير من نوع آخر يقف فيها أناس أمام لجان الترشيح للانتخابات المحلية، تبين فيما بعد أنهم موظفون، حشدهم الأمن لعرقلة أو منع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من تقديم أوراق ترشحهم. وبينما دلّ المشهد الأول على تفاقم واستحكام الأزمة الاقتصادية، خاصة أزمة المعيشة التي تعاني منها الأغلبية الساحقة في مصر، دلّ المشهد الثاني على تفاقم واستحكام الأزمة السياسية وانسداد أفق الإصلاح وتلاشي آمال التحول الديمقراطي بالوسائل السلمية، وهو ما رسخه مؤخرا مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين..
ولأن أحدا لا يملك في الوقت الراهن إجابة واضحة ودقيقة عن سؤال: مصر إلى أين؟، فمن الطبيعي أن تتعدد الاجتهادات، حسب زوايا الرؤية. غير أن أي محاولة للإجابة عن هذا السؤال تتطلب أولا، وفي جميع الأحوال، فهم الأسباب التي أدت إلى وصول الأوضاع في مصر إلى ما هي عليه الآن.
للأزمة الراهنة في مصر أسباب عميقة الجذور، أهمها في تقديري:
1- أزمة قيادة سياسية، تباينت أنماطها إلى حد التناقض منذ عام 52 حتى الآن. 2- فشل إدارة عملية الانتقال من الحزب الواحد إلى التعددية السياسية. 3- ضعف قوى المعارضة وعجزها عن طرح بديل للتحول السلمي نحو الديمقراطية، وسوف نناقش هذه العوامل تباعا في هذه السلسلة من المقالات.
فقد تعاقب على حكم مصر منذ منتصف القرن الماضي - إذا استثنينا محمد نجيب- ثلاثة زعماء ينتمي كل منهم إلى نمط مختلف تماما من أنماط القيادة: النمط الثوري، ومثّله جمال عبدالناصر، والنمط المغامر، ومثّله أنور السادات، والنمط البيروقراطي ومثّله حسني مبارك، ورغم التباين الهائل في السمات الشخصية والتوجهات العقائدية لهذه الأنماط الثلاثة، وما ترتب عليه من تباين مماثل في السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها كل منهم، فإن النظام السياسي، الذي استحدثته ثورة 1952، بقي دون تغيير يذكر، وهو عامل ربما يفسر وجود سمات وقواسم كثيرة مشتركة بين هذه القيادات، يمكن في تقديري، إجمال أهمها على النحو التالي:
السمة الأولى: انتفاء الرغبة في التخلي طواعية عن السلطة، فالرئيس عبدالناصر تخلى عن السلطة بالموت الطبيعي، والرئيس السادات أجبر على تركها بالاغتيال، أما الرئيس مبارك - أمد الله في عمره- فلا يزال يمارسها، وسبق له أن أفصح صراحة عن نيته في البقاء فيها طالما ظل في جسده عرق ينبض!
السمة الثانية: تركة ثقيلة تورثها القيادة السابقة للقيادة اللاحقة، فالرئيس عبد الناصر رحل وسيناء لا تزال محتلة وجرح هزيمة 67 لا يزال مفتوحا لم يندمل بعد، والرئيس السادات رحل في ظل حالة من الاحتقان الداخلي والقطيعة مع العالم العربي، لم تشهد مصر لهما مثيلا في تاريخها. ورغم صعوبة التكهن بما ستكون عليه أحوال مصر عند انتقال السلطة إلى خليفة الرئيس مبارك، فإن المؤشرات المتاحة لا تبشر بأي خير.
السمة الثالثة: عدم مشاركة الشعب في اختيار أي من هذه القيادات الثلاث. فالرئيس عبدالناصر وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري. صحيح أن الانقلاب تحول بسرعة إلى ثورة أيدها الشعب، وصحيح أيضا أن عبدالناصر تمتع بشعبية طاغية بدت واضحة، حتى وهو مهزوم، وعبر عنها رفض الشعب المصري تنحي زعيمه بعد هزيمة يونيو، ثم خروجه عن بكرة أبيه لوداعه في جنازته، غير أن عبدالناصر لم يخض أبدا تجربة انتخابات، نافسه فيها أحد، أما السادات فقد جاء باختيار من عبدالناصر، ولأسباب لا يعلمها إلا الله وحده، وكذلك الحال بالنسبة لمبارك، الذي اختاره السادات وحده ولأسباب لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده أيضا، أما الاستفتاءات التي تمت فأقل ما يقال فيها إنها كانت شكلية ونتائجها غير صحيحة، بل مفبركة من الأساس. ويقال الآن إن مبارك أصبح بعد تعديل المادة 76 من الدستور أول رئيس جمهورية في تاريخ مصر ينتخب من بين أكثر من مرشح، إلا أن الكل يعلم أن هذه الانتخابات كانت شكلية وأقرب ما تكون إلى «زفة دعائية إعلامية» لا تليق بشعب عريق كالشعب المصري.
السمة الرابعة: انطلاق آمال عريضة في التغيير مع بداية ولاية كل رئيس، ما تلبث أن تخفت تدريجيا إلى أن تتلاشى تماما مع تحول الحاكم القادم إلى فرعون جديد، على طريقته، بعدها تبدأ حالة من السخط العام تتصاعد تدريجيا إلى أن تصل ذروتها في نهاية كل حقبة.
فخلال فترة زمنية لم تتجاوز سبع سنوات، كان عبدالناصر قد أنجز إصلاحا زراعيا واسع النطاق، وحقق مطلبي الاستقلال والجلاء بإنهاء الاحتلال البريطاني لمصر، وأمم قناة السويس، وبدأ بناء السد العالي، وأقام وحدة اندماجية مع سوريا، لكن النكسات ما لبثت أن توالت بعد ذلك تباعا: انفصال سوريا عن مصر، اندلاع حرب عربية - عربية على أرض اليمن، هزيمة 67 إلخ. أما السادات فحقق إنجازا عسكريا مهما بعد ثلاث سنوات فقط من توليه السلطة، ثم شرع في عملية انفتاح سياسي واقتصادي، بدت واعدة في البداية، لكنه رحل مخلفا وراءه تركة ثقيلة جدا، بدأت مع تنامي ظاهرة العنف والتطرف الديني وانتهت بانتكاسة لعملية الإصلاح السياسي، مع دخوله، بزيارة القدس، في مغامرة غير مأمونة العواقب، أدت إلى عزل مصر عن عمقها الطبيعي وإضعاف دورها ورهن إرادتها.
وفي سنوات حكمه الأولى، استطاع الرئيس مبارك تخفيف حدة احتقان سياسي كانت قد جسدته أحداث سبتمبر 1981، كما استطاع احتواء ظاهرة العنف والتطرف الديني، وإعادة جامعة الدول العربية إلى مقرها في القاهرة والشروع في ترميم البنية التحتية، وعندما استقرت له الأوضاع بمرور الوقت، لم يعد نظامه منهمكا بشيء قدر اهتمامه بالمحافظة على بقائه هو، دون أي اعتبار آخر، وهنا بدأت تتشكل بؤر فساد، ما لبثت أن اتسعت تدريجيا إلى أن تسببت في خلق حالة غير مسبوقة من الاستقطاب الاجتماعي بين قلة تزايد ثراؤها بشكل فاحش وغير مبرر، وأغلبية كاسحة تزايد بؤسها بشكل ظالم ووحشي، وتواكب ذلك مع تدهور عام في مستوى الخدمات من تعليم وصحة ومواصلات وغيرها، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من: فوضى ونذر مجاعة وانسداد أفق التغيير والإصلاح.
غير أن هذا التشابه الظاهري في أداء النظام السياسي المصري يجب ألا يخفي عمق الاختلافات في الرؤى والسياسات المتبعة في كل مرحلة. فقد كان لعبدالناصر والسادات، بحكم تكوينهما الشخصي وتاريخهما النضالي، رؤية سياسية واضحة، افتقدها الرئيس مبارك تماما.
صحيح أن رؤية السادات تناقضت كليا تقريبا مع رؤية عبدالناصر، لكن كلتا الرؤيتين استندت إلى قواعد سياسية واجتماعية، وبالتالي أيديولوجية واضحة ومحددة. وبينما عبرت إحدى الرؤيتين، إجمالا، عن أطروحات اليسار المصري ومصالح الطبقة الوسطى والطبقات الكادحة، عبرت الرؤية الأخرى عن أطروحات اليمين ومصالح طبقة التجار ورجال الأعمال. أما الرئيس مبارك، فبالإضافة إلى افتقاده أي رؤية سياسية، اختلف عن سلفيه في أمرين آخرين على جانب كبير من الأهمية:
أولهما: إدارة الدولة بمنطق التسيير الذاتي اليومي والبيروقراطي، مع تركيز اهتمامه فقط على كل ما من شأنه أن يشكل تحديا لسلطته أو لإرادته كحاكم، ونجاحه المذهل في هذه السياسة، لدرجة أنه تمكن من الاحتفاظ بالسلطة فترة توازي - حتى الآن فقط- مجموع سنوات حكم عبدالناصر والسادات معا.
وثانيهما: رفض تعيين نائب له، مع السماح في الوقت نفسه لنجله جمال بلعب دور سياسي، راح يتنامى بسرعة إلى أن استقر في الضمير العام، خطأ أو صوابا، أن هناك عملية سرية مخططة تجري لإعداده لتولي السلطة في الوقت المناسب، دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بسقف زمني أو بسيناريو محدد لكيفية نقل السلطة، شريطة ألا يبدو «توريثا» بالمعنى المتعارف عليه!
بعبارة أخرى يمكن القول إن رؤساء مصر الثلاثة بدأوا دائما فترات حكمهم بطرح برنامج للتغيير، كان الشعب يأمل أن يفضي في نهاية المطاف إلى إرساء قواعد لنظام ديمقراطي حقيقي، وانتهى في كل مرة - وللأسف الشديد- بتعبيد الطريق أمام فرعون من نوع جديد


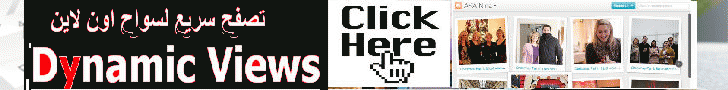


0 comments:
إرسال تعليق