يوم أمس كان اليوم الرابع، والمفترض الأخير، للحوار اللبناني في الدوحة. لم يتوصل أقطاب الأزمة في نهايته إلى اتفاق. تأجلت النتيجة إلى اليوم. وهذه ليست نتيجة مفاجئة. التسريبات تقول إن المعارصة هي من طلب التأجيل. ما جرى كان حواراً سياسياً تعذر في لبنان، فانتقل إلى الدوحة. ولم يكن من الصعب ملاحظة أن الانتقال مؤشر على فشل محتمل. استؤنف الحوار بعد توقف في بيروت لأكثر من سنة، وبعد أن تخطى عمر الأزمة أكثر من ثلاث سنوات. الأخطر أنه استؤنف بعد محاولة أقوى أطراف الأزمة تنفيذ انقلاب عسكري في العاصمة. هل هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق اليوم من خلال الحوار السياسي؟
ما يفرق بين المعارضة والموالاة، ليس من النوع الذي يسمح بسهولة إحداث اختراق يؤدي إلى التوفيق بينهما. بل يبدو أن الخلاف وصل إلى، أو يقترب من القطيعة. لم يكن حوار الدوحة مباشراً بين طرفي الأزمة، بل بواسطة أعضاء اللجنة العربية الوزارية، وخاصة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم، وأمين عام الجامعة العربية، عمرو موسى. لم يجلس أعضاء الموالاة والمعارضة، أو يتحدثوا إلى بعضهم بعضا، عدا حالات فردية واستثنائية تمت بالمصادفة في ردهات "الشيراتون". يبدو أن ما بقي من معالم الود والثقة بين الطرفين يتلاشى، وبشكل سريع.
جرب اللبنانيون أزمات كثيرة من قبل، أزمات لا تقل شراسة عن الأزمة الحالية، لكنهم، وإن بمساعدة خارجية، توصلوا إلى اتفاق. آخر هذه الأزمات كانت الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً. لكن من الواضح الآن أن الاتفاقات السابقة لم تؤد إلى حل. على العكس، ساعدت في تراكم عناصر الأزمة. وربما هذا هو السبب في أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ لبنان: طبيعتها مختلفة، والرهانات فيها أكبر وأكثر خطورة، وظرفها الإقليمي مختلف. أميركا في المنطقة، وسوريا خرجت عسكر
 ياً من لبنان، وإسرائيل خرجت من أغلب لبنان. لكن إيران دخلت لتحل محل سوريا من خلال "حزب الله". إيران تختلف عن سوريا في أشياء كثيرة، ليس أقلها أنها دولة غير عربية تعمل على نشر نفوذها في عمق العالم العربي. هوية إيران الشيعية، ودخولها في محيط سني من خلال قوة محلية شيعية سيؤدي في الأغلب إلى تفجير طائفي في لبنان والمنطقة.
ياً من لبنان، وإسرائيل خرجت من أغلب لبنان. لكن إيران دخلت لتحل محل سوريا من خلال "حزب الله". إيران تختلف عن سوريا في أشياء كثيرة، ليس أقلها أنها دولة غير عربية تعمل على نشر نفوذها في عمق العالم العربي. هوية إيران الشيعية، ودخولها في محيط سني من خلال قوة محلية شيعية سيؤدي في الأغلب إلى تفجير طائفي في لبنان والمنطقة.كانت الأزمات السابقة تدور من أجل الدولة، وداخل إطارها بكل هشاشته. الأزمة الحالية ليست كذلك. هي في حقيقتها بين الدولة من ناحية وبين إحدى القوى السياسية، أو "حزب الله". يختلف هذا الحزب عن الأطراف الأخرى في كل شيء تقريباً. هو الطرف الوحيد الذي يستحوذ على شعار المقاومة، ويستخدمه كمبرر لوجوده، ولتميزه واختلافه عن الأطراف الأخرى. هو الذي يقرر ما هي المقاومة، ومن ينخرط فيها، ومتى تبدأ ومتى تتوقف، ولأي هدف. بعبارة أخرى، يمسك الحزب بقرار الحرب والسلم باسم المقاومة؟ لا يقبل الحزب غير التسليم بتميزه عن غيره بشعار المقاومة. ليس للدولة أن تتدخل في ذلك، لأنها دولة غير مؤتمنة. فهي دولة "ديفيد ولش" أحياناً، ودولة وليد جنبلاط أحياناً أخرى، وفي كل الأحيان هي دولة المشروع الأميركي! "حزب الله" هو الطرف الوحيد المسلح، والذي تتجاوز قدراته العسكرية قدرات جيش الدولة نفسها بمراحل. هو حزب ديني، وقيادته دينية، ومرتبط مع دولة خارجية يحكمها نظام ديني، هي إيران. يرتبط معها بعلاقات استراتيجية بمعزل عن الدولة. تمويل الحزب إيراني، وتدريب كوادره يتم على أيدٍ إيرانية. مرجعيته الأيديولوجية هي مرشد الثورة الإيرانية، وفكرة ولاية الفقيه. هنا تبدو مفارقة لبنان ومكمن أزمته الحالية: دولة أساسها الدستوري علماني، وتركيبتها طائفية، وأقوى أطرافها السياسية حزب ديني مرتبط مع خارج ديني.
أثناء الحرب الأهلية كانت سوريا في لبنان، وكان اللبنانيون يشتكون من أنها ترفض تبادل التمثيل الدبلوماسي معهم. رغم ذلك كانت علاقة سوريا مع الدولة، ومع جميع الأطراف اللبنانيين. حالياً تغير الأمر. إيران ليست موجودة في لبنان، لكن علاقتها ليست مع الدولة اللبنانية، وإنما مع طرف مناهض للدولة. تغيّرُ المشهدِ على هذا النحو مكّن "حزب الله"، بمساعدة إيرانية وسورية، من أن يتحول إلى دولة داخل الدولة. قوته العسكرية، مصادر تمويله، أيديولوجيته، وقاعدته الشعبية، كل ذلك بمعزل عن الدولة. الدولة تخشى قوة "حزب الله"، وليس العكس. الأكثرية هي التي تبحث عن ضمانات لحمايتها من فريق واحد في المعارضة. في العادة تكون المعارضة هي التي تبحث عن ضمانات أمام وطأة الدولة وجبروتها. لكن الحالة اللبنانية عكست الآية تماماً. كيف يمكن حل الأزمة الحالية من دون حل هذه المعضلة؟
تشخيص الأزمة على هذا النحو لا يعني بأي شكل أن مسؤوليتها تقع على المعارضة وحدها. الأكثرية مسؤولة أيضاً على أكثر من مستوى، على الأقل لأنها كانت حاضرة في كل الأزمات السابقة، وسمحت لها بأن تنتهي إلى ما انتهت إليه حالياً. يكفي أن ما حصل ويحصل في لبنان هو صدام بين منطقين: منطق دولة فاشلة، ومنطق دولة أخرى تبدو في طور التشكل، أو دولة الحزب. بعد الانقلاب أخذت الأزمة اللبنانية الصورة التالية: حكومة تتخذ قراراً. يتحرك أحد أحزاب الدولة ويرغمها عسكريا على التراجع عن قرارها رسمياً، وبشكل علني. من الذي يملك سلطة القرار في هذه الحالة؟ نظرياً تستطيع الحكومة إصدار القرارات. عمليا "حزب الله" وحده من يملك القوة الحقيقية على الأرض. بإمكانه، نظرياً على الأقل، فرض خياراته على الحكومة. وبما أن الحكومة هي التجسيد المادي للدولة، تمتد خيارات الحزب لتشمل الدولة أيضاً. من هذه الزاوية، لم تعد الدولة اللبنانية هي المؤسسة الوحيدة التي تملك أدوات العنف، وتملك مشروعية استخدامها. أصبح للدولة شريك في ذلك باسم المقاومة، مع فارق، وهو أن الشريك أقوى من الدولة. حتى حق الدولة في مشروعية استخدام العنف أخذ يتراجع أمام شعار المقاومة. ما هي هذه المقاومة التي تريد أن تحرر الأرض لتستولي على الدولة، أو لتحل محلها؟
من هنا يقتضي الأمر شيئاً من المراجعة. الأزمة اللبنانية الحالية ليست أزمة سياسية بالمعنى المتداول. على السطح يدور الجدل حول مسائل مثل قانون الانتخابات وما يستتبعه من توزيع للمقاعد البرلمانية وفقاً للتركيبة الطائفية للبلد. ويدور أيضاً حول توزيع المناصب الوزارية في الحكومة المنتظرة. لكن الأزمة في حقيقتها ليست كذلك. هي ليست أزمة سوء تفاهم، أو صراع على قرارات في البرلمان بين أكثرية ومعارضة. وهي ليست مرتبطة بموضوع النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الدولة. هي كذلك بالنسبة لفريق، لكن ليس بالنسبة لكل الفرقاء. في الظاهر هي كل تلك العناوين مجتمعة، لكنها في العمق أكثر تعقيداً، وأكثر خطورة. ما يطفو على السطح ليس أكثر من عناوين لما هو أبعد. الأزمة اللبنانية في العمق هي أزمة حكم: طبيعة الدولة، والتوازنات الطائفية فيها، تحالفاتها الخارجية، هويتها، واستراتيجيتها في الداخل والخارج، توزيع السلطات والحقوق في هذه الدولة، طبيعة علاقتها بالمجتمع، ومع الطوائف التي يتكون منها هذا المجتمع، وتحديداً القوى السياسية التي تمثل هذه الطوائف. ولأنها كذلك، تحولت مع الوقت إلى أزمات تنفجر بشكل دوري ودائم منذ تأسيس الجمهورية في عشرينيات القرن الماضي. والأزمة اللبنانية ليست أزمة محلية، بل تتداخل فيها مصالح وتحالفات إقليمية ودولية. حتى نشأة الدولة في بداياتها لم تكن على يد قوى محلية، أو استجابة لمصالح وطنية. بل دخلت فيها قوى ومصالح إقليمية ودولية أيضاً. مأساة لبنان أنه كان منذ بدايته مركز تقاطع لهذه القوى والمصالح. والأغرب أن قواه السياسية بقيت مرتهنة لتلك القوى والمصالح حتى هذه اللحظة.
أراد الوسطاء العرب تحقيق شيء من الاختراق. مشكلتهم أنهم يتعاملون مع مظاهر الأزمة. هم لا يجهلون حقيقة الأمور. على العكس هم يعرفون حقيقة الأمور، لكن قناعتهم أن ملامسة الحقيقة تفرض اتخاذ مواقف واضحة ومباشرة من هذا الطرف أو ذاك. وهذا تحديداً ما يصرون على تفاديه. الوصول بالحوار إلى نقطة المكاشفة، وتحديد المواقف بشكل واضح ومباشر، سيزيد من تفجير الأزمة. خيار الحلول الرمادية أفضل لتفادي الانفجار. التجارب التاريخية للأزمات العربية، وطريقة مقاربتها لم تحل أزمة حتى الآن. أفضل ما حققته هو تأجيلها لتنفجر لاحقاً بشكل أكثر عنفاً وتدميراً. أزمة الغزو العراقي للكويت كانت آخر الأزمات العربية التي استقرت على هذه النهاية. وأزمة الحرب الأهلية اللبنانية عادت الآن وانفجرت في وجوه الجميع، وما زلنا نقارب الموضوع بالمنهج ذاته.


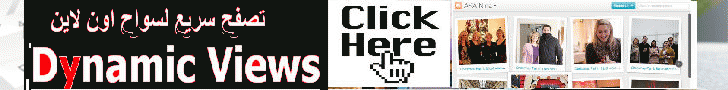



0 comments:
إرسال تعليق