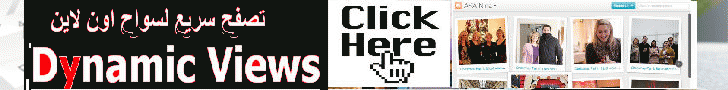من بندقية صيد رافقته في أجمل رحلات عمره، وذات يوم من العام 1961، أطلق الكاتب الأميركي ارنست همنغواي النار على رأسه ووضع حداً لحياته كي لا يتسنّى "لشيخ الرواية" ان يعيش تجربة بطله "شيخ البحر" في مصارعته للوجود بكل ما بقي فيه من قوة، فرحل عن 62 عاماً و25 كتاباً موزعاً بين الرواية والقصة القصيرة: "وداعاً أيها السلاح"، "الشمس تشرق أيضاً"، "الذين يملكون والذين لا يملكون"، "وليمة متنقلة"، "لمن تُقرع الأجراس" و"الشيخ والبحر"... وغيرها من الأعمال التي كتبها من وحي تجاربه الشخصية وتركت بصمتها على الأدب الأميركي الذي صار همنغواي واحداً من أعمدته...
وتصادف هذا العام الذكرى الستون لرحيله ويتذكر الأميركيون كما كل قرائه في العالم مسيرة هذا الرجل الذي كتب من ألم وكتب عن أبطال وشخصيات يتحمّلون المصاعب والآلام في تجارب حياتية قاسية دوّنها في روايات خالدة.
كيف عاش همنغواي؟ ومن أين ولد أبطاله؟ لماذا انتحر بعد ان كان طوال حياته يلوم والده على انتحاره؟ كيف شغل هذا الكاتب النجم الصحافة الأميركية والعالمية في يومياته؟ وكيف طغت صورته المحببة على غلافات المجلات ليكسب شعبية اضافية بجمالية اطلالته المغايرة: اللحية البيضاء الطويلة وقبعات الصيد والسمرة التي كان يكتسبها من رحلاته ومغامراته في الطبيعة؟ وأجراس همنغواي التي قرعها في حياته لم تسكت، وبعد رحيله وكان يحتفظ بمخطوطات كثيرة، بدأ نشرها تباعاً وما بين 1964 و1999 قرأ العالم من أعمال همنغواي: "باريس عيد" و"جزر على وشك الانجراف"، "ومغامرات نيك آدامز" و"حديقة عدن" و"الساخن والبارد" و"الحقيقة على ضوء الفجر"... وكأن همنغواي لم يرحل، وكأنه اختبأ من ظلم الحياة وقسوة المرض وراح يرسل من مكانه الخفي أوراقه تباعاً، تلك الأوراق المكتوبة بالدم والدمع وليس أقل. فالروائي همنغواي وإن أبصر النور وسط عائلة ميسورة ومن والدين مثقفين دعماه للوصول الى ما هو عليه، إلا انه عرف في كل فصول حياته المآسي والصعاب والآلام الجسدية والنفسية. لم يكتب همنغواي سوى الصعب والدامي ولم يختر من تجاربه سوى الشديد الألم ليقول احساسه بالحياة. لكنه من ناحية ثانية، عرف كيف يستفيد من عذاباته وكيف يوظفه ايجاباً، فهو كتب ذات يوم: "أفضل ما يمكن ان يحصل لكاتب هو ان تكون طفولته على شيء من التعاسة، وكلما ازداد البؤس والحزن والفقر والقلق والألم، ظهرت الى العلم موهبته في التعبير عن كل ما يختلج في الروح وكل ما يطل من الذاكرة".
لم تكن ولادة ارنست الصغير عادية، فذاك المولود الجميل الذي أبصر النور في 21 تموز من العام 1899 في منطقة أواك بارك في شيكاغو أضفى سعادة على العائلة التي استقبلت الابن البكر بحفاوة وسيكون له بعد سنوات أربع شقيقات وأخ صغير: الأم وتدعى غرايس هال مطربة أوبرالية كانت تشارك في حفلات محلية في المنطقة ووالده كلارنس همنغواي كان طبيب أسنان، غير انه كان يهوى الصيد والرحلات في الطبيعة، فبدأ ابنه ارنست يرافقه قبل العاشرة، واشترى له بندقية في العاشرة. أما هذه الرحلات فالحديث عنها لأنها ستكون ذات صلة وثيقة بكل ما سيكتبه همنغواي، وفي الطبيعة ستتفتح أفكاره المذهلة، وسيكتب ويعيش فترات طويلة من حياته في الغابات أو قرب شاطئ البحر، وسيكتب من وحي رحلات الصيد البحرية المذهلة التي سيختبرها بقوة وشغف في رائعته "الشيخ والبحر" والتي ستكون الحافز الأول والمباشر لجعل لجنة نوبل تكرّمه بجائزة "نوبل للآداب" عام 1954.
محرر
منذ سن المراهقة حلم ارنست بأن يصبح كاتباً فلم يدخل الجامعة بحجة ان سنوات طويلة للدراسة ستفصله عن التفرغ للكتابة، فعمل منذ العام 1917 وكان في الثامنة عشرة محرراً في "كانساس سيتي ستار" وفي نفس الوقت سحرته فكرة ان ينجح في الحياة العسكرية وكان ذلك بأثر من دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب العالمية الأولى وفي مذكرات لاحقة يتذكر ارنست هذه المرحلة ويشرحها ويحللها بنفسه معتبراً انه كان بصدد البحث عن مهنة معينة "خاصة بالرجال" ليثبت رجوليته ونضجه بسبب سوء تربية والدته له التي كانت ترغب في تحويله الى "فتاة دمية" في طفولته بسبب جمال وجهه، فكانت تترك شعره يطول كالفتيات وهذا واضح في صوره من تلك المرحلة وتجعله يرتدي الفساتين وتقول لصديقاتها وأقربائها: "ألم يكن من الأفضل لو ولد بنتاً؟" هذا الأمر استمر حتى بلغ سناً تجعله يرفض ويثور، وهو كتب عن والدته وعن تلك المرحلة معتبراً انها كانت امرأة هستيرية وأنانية.
غير ان رغبته في دخول الجيش لم تتحقق بسبب رسوبه في الفحص الطبي فهو كان يعاني قصر النظر بشدة وكان يرفض وضع نظارتين، وهذا السبب وكتبه في مذكراته أيضاً أي قصر النظر جعله أيضاً يتخلى عن الدراسة الجامعية، فهو كان عاجزاً عن متابعة الدروس والشرح على اللوح البعيد، فاكتفى بالكتاب والمطالعة عن قرب. لكن كل هذا لم يمنعه من الالتحاق بكتيبة سيارات الإسعاف في الجيش وبعد ثلاثة أسابيع من العمل أصيب بجروح اثر انفجار قنبلة بالقرب منه في ايطاليا وكان ذلك في العام 1918 فقضى ستة أشهر في المستشفى ومع عودته الى بلدته استُقبل كالأبطال خاصة بعد ان عرف الجميع انه أصيب بسبب إصراره على إنقاذ جرحى في الحرب. لكن رجوعه لم يلبث ان جعله يدخل مجدداً في أحزان كبيرة حين مرض والده ثم انتحر، فالقى كل اللوم على والدته وحملها مسؤولية انتحار والده.
القطيعة
وهنا بدأت القطيعة مع مرحلة الطفولة والمراهقة في حياة همنغواي حيث قرر الابتعاد والبدء بحياة جديدة بدأت معها الكتابة.
باريس والكتابة: "الشمس تشرق أيضاً. ومع وصوله الى باريس عام 1920 "، وكان همنغواي قد تزوج بامرأة تدعى هادلي ريتشاردسون وكانت تكبره بأكثر من ثمانية أعوام، فانطلق من شقتهما الصغيرة في العاصمة الفرنسية الى اكتشاف عالم الأدب والثقافة، وفي باريس التقى جيرترود ستاين وإزرا باوند وسكوت فيتزجيرالد وشرود أندرسون وغيرهم من الكتّاب الأميركيين المقيمين في فرنسا، فصار جزءاً من مجموعة المغتربين في العشرينيات التي أسستها جيرترود ستاين وعرفت باسم "الجيل الضائع"، ولقي من بعضهم المساعدة لنشر أول أعماله وكانت المجموعة القصصية "في زمننا" التي نشرت في أميركا عام 1925 وبعدها رائعته "الشمس تسطع أيضاً" عام 1926 وهي الرواية التي جعلته يبرز كواحدٍ من الروائيين المتميزين الشباب مع انها وحسب رأي النقّاد امتازت ببساطة متناهية وبالخلو من التعقيد، وجاءت بأحداثها لتبدو مفرطة في الواقعية وقد عالج فيها موضوع الاحتفالات السنوية التي تجري سنوياً في اسبانيا في مجال مصارعة الثيران، وقد حلل نقطة دقيقة وحساسة في الموضوع وهي انه لا بد دائماً من قتيل في هذه المصارعة: الثور أم المصارع؟
وقد اعتبر عدد كبير من النقّاد ان الرواية جاءت في غاية الحساسية بسبب شغف همنغواي بفكرة الموت في تلك المرحلة كما شغفه بفكرة اثبات رجوليته عبر بطليه اللذين يتحادثان عبر كل فصول الرواية حول الحب والمرأة والجسد والجنس، فصنّف الكتاب أيضاً في خانة "الأدب البعيد عن الأخلاقيات" وذهب البعض في اتجاه معاكس الى اعتباره "أبرز رواية تصوّر حياة جيل الشباب الضائع في تلك المرحلة".
"وداعاً أيها السلاح"
نجاح روايته الأولى أعطاه دعماً معنوياً للكتابة من جديد، فاستمرت كتبه بالتألق خاصة مجموعات القصص القصيرة التي أطلقها في السنوات 1927 و1928 ووضع فيها تقنية السرد الصحافية الى حد ما واتصفت بالوصف المباشر، الى ان ظهرت رواية "وداعاً أيها السلاح" واعتبرت من أفضل الروايات التي كتبت في تلك المرحلة ضد الحرب.
وتدور أحداثها حول بطله الشاب فريديريك هنري الذي أدرك من خلال الحب حماقة المشاركة بالحرب وما ينتج عنها من دمار نفسي وخارجي محاولاً تحقيق سلامه الداخلي خارج الخضوع التقليدي للظروف والواقع.
واعتبرت "وداعاً أيها السلاح" من أبرز الأعمال التي سمحت بالمرور الى الرواية المعاصرة عبر كل ما قدمته من أفكار حول التأثير السلبي والعالمي للحروب والشرور الذي لا مفر لنا منه جميعنا وكيف انه هناك دائماً أحدهم ليدفع ثمن الشجاعة والحب والاحساس الإنساني العميق.
وتماماً كما جذبت الحرب العالمية الأولى همنغواي لأن ينخرط في صفوف المقاتلين، حدث كذلك حين قرر العمل كمراسل حرب في اسبانيا خلال الحرب الأهلية فيها وكذلك على جبهة الحرب العالمية الثانية، حيث كان يراسل مجلات عديدة. وثمة موضوع جديد بدأ يشغله في تلك الآونة وقد وصفه في مجمل أعماله وهو حول كيفية الحفاظ على موهبته ككاتب في مواجهة كل تهديدات الحياة في الحروب كذلك التهديدات من نوع آخر والتي تولدها الحرب أيضاً مثل ضياع القيم والثوابت في المجتمعات وأيضاً السعي وراء المال والنجاح والشهرة كتعويض عن نواقص كثيرة في الأزمات. كل هذا وضعه في روايته التالية وكان عنوانها: "ثلوج كليمانجارو" التي نشرها عام 1936، ومن بعدها رواية "لمن تُقرع الأجراس" عام 1940 وقد وضع فيها كل هذه الأفكار التي تبنّاها وتبدو فيها أجواء الريف الاسباني وأهله الذين وصفهم وصفاً دقيقاً ومؤثراً في ذلك الكتاب.
الشيخ والبحر
من "لمن تُقرع الأجراس" الى "الشيخ والبحر" ولكن ما بين روايته "لمن تُقرع الأجراس" وأجوائها الريفية وروايته "الشيخ والبحر" 1952 التي تعتبر ملحمة بحرية بامتياز أو بتعبير آخر من الأعمال الأدبية التي وصفت عالم البحر ومجّدته عبر غوص في أعماقه وأسراره الغامضة، ثمة تغيير حدث في حياة همنغواي الذين غاص شيئاً فشيئاً في حياة بوهيمية، وصار البحر الواسع مشهداً مؤثراً في يومياته حيث كان يمضي نهاراته في هواية الصيد التي لم تكن فقط محدودة في معانيها وأهدافها.
فلم يكن الصيد في حياة همنغواي لمجرد الحصول على نتيجة وافرة من أسماك ولا لمتعة الهواية لتمضية الوقت، بل كانت في رمزيتها ذاك الغوص اليومي والمتكرر في مجاهل البحار والحياة وكأنه يبحث عن مجهول في ذاك المشهد البحري الهائل الذي صوّره عبر شخصيته الروائية، ذاك الشيخ العجوز في صراعه مع البحر. فقد صورت رواية "الشيخ والبحر" البعد الآخر للقوة الجسدية والنفسية للإنسان في صراعه للبقاء عبر شخصية العجوز الذي يتحدى قوة الطبيعة في صراعه أيضاً مع السمكة الضخمة التي اصطادها ذات يوم. غير ان صراعه يتسم بالوحدة والعزلة حيث عاشهما وحيداً، لا عون له في مواجهة شرسة بقوة حب البقاء. وبطله الشيخ ويدعى سانتياغو عاش يأساً كبيراً بعد ان أمضى شهوراً عدة يصطاد من دون ان يحصل على نتيجة، وتحديداً 84 يوماً، وفي اليوم الخامس والثمانين، اصطاد سمكة ضخمة بقي يصارعها لمدة يومين ليلاً ونهاراً، متحدياً التعب والجوع وعدم النوم والألم الناتج عن الجروح التي تعرض لها في معركته الأقرب الى الأسطورية، ليواجه في مرحلة ثانية وبعد ان اصطاد سمكته، أسماك القرش المفترسة التي هاجمته في طريق عودته الى منزله البحري على الشاطئ، فقد عاد أخيراً لكنه عاد مع ما بقي من صيده: حسكة ورأس سمكة مهمش.
"الشيخ والبحر" اعتبرها العالم بمثابة الملحمة الإنسانية التي رمزت بقوة وجمالية فائقتين الى حياة الإنسان وسعيه في مصارعة القوى المحيطة به بإرادة صلبة وشجاعة لا مثيل لها ليصل أخيراً خاوي اليدين في مواجهة الواقع المرير. ولقد أجمع النقّاد أيضاً على ان هذه الرواية البحرية بامتياز هي صورة طبق الأصل عن واقع حياة الكاتب في الفصل الأخير من حياته حين عاش لفترة طويلة ملازماً للبحر، وليس سانتياغو سوى صورة عنه بعد ان عاش حياته يصارع ويتحدى الأقدار حتى وصل الى مرحلة فقد فيها قواه الجسدية والروحية في آنٍ. لكن روايته هذه لم تكن مقفلة على اليأس بل وضعها في إطار الأمل عبر شخصية الولد الصغير والصديق للعجوز والمعجب به التي استمر يرافقه في رحلاته وكأنه صورة عن الأمل والحياة المتجددة، كما ان الشيخ وبعد تجربته هذه، عاود النزول بمركبه الى البحر للصيد ولاختبار المجهول ثانية. هذا الصراع الرائع للإنسانية الذي صوره همنغواي في "الشيخ والبحر" كرسّته "جائزة نوبل للآداب" واحداً من الروائع الأدبية الخالدة.
ولقد لقّب همنغواي بعدد من الألقاب كان أبرزها "بابا" أي الأب الروحي والفعلي للرواية الحديثة والمعاصرة التي ستعرف منذ تلك المرحلة، أي منتصف الخمسينيات من القرن العشرين،التمرد والانطلاق والتجدد. واذا غلبت النظرة السوداوية للعالم في كتاباته الأولى فهو تفاعل وتجدد في مراحل متفرقة من حياته الأدبية وعمل عبر رواياته الأخيرة على تمجيد القوة النفسية وقوة العقل لدى الانسان، فصور هذه القوة في تحدياتها لقوى الطبيعة في صراعات متنوعة. ولقد عكست مؤلفات همنغواي أيضاً تجاربه الشخصية، فهو عاش وشارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية كما الحرب الأهلية في اسبانيا، فأصيب في المعارك وراقب من كثب آلام الآخرين فكتب عن أبطال يتحملون المصاعب والآلام من دون شكوى وتعكس هذه الشخصيات طبيعته الشخصية. أما أسلوب همنغواي الذي وصف معظم النقاد بالسهل والواضح والعفوي وقد كان متقناً نتيجة ممارسته الطويلة للكتابة الصحافية حيث أفادته كتابة التقارير وحتى السياسي منها في تقصي الحقائق من حول الأحداث التي يعيشها، ولعل أفضل وصف لأسلوبه في الكتابة هو ما وضعه بنفسه، فقد صرح ذات يوم بأنه يهيئ أغلب أعماله في ذهنه أولاً.. "ولا أبدأ الكتابة قبل ان تكون أفكاري قد نظمت جيداً. وكثيراً ما أقوم بتلاوة نصوص من أي حوار اكتبه وبالطريقة التي ستكون عليه عند كتابتها، فأنا أؤمن بأن الأذن هي أفضل وأحسن مراقب أو ناقد.. ثم لا أكتب أي جملة على الورق قبل ان اتيقن بأن الطريقة التي سأعبر بها ستكون مفهومة وواضحة تمام الوضوح للجميع..".
.. الى العزلة في هافانا
ثمة من كتب سيرة همنغواي ولخص التغيير في سنواته الأخيرة بالتالي: "بعد الحرب، لم يعد همنغواي كما كان" بدأت تنقصه الحركة كذلك الحيوية والنشاط، وبطل الحروب صار اقل من انسان عادي.."
في تلك المرحلة تغيرت شخصية الكاتب وحسب كل المقربين منه: "ثمة ما تبدل في شخصيته" وقد اعتبر بعض المحللين ان الأمر يعود الى وراثة في العائلة، فوالده عاش اضطرابات في شخصيته بعد سن معينة وانتحر، كذلك انتحرت اثنتان من شقيقات الكاتب، وستنتحر عام 1996 حفيدته الممثلة الهوليودية مارغوهمنغواي.
وما لبث ان اصبح همنغواي عنيفاً ومنعزلاً وذهب الى اقصى حدود الخيانة ان مع نسائه وان مع اصدقائه، فقد وصف أكثر من صديق "بالخائن".
أما الذي لم يعرفه عنه هؤلاء الأصدقاء الذين هجروه هو انه كان على طريق خيانة نفسه ايضاً، وكان ان اعتقد بأنه سيتغير مع تبديل مكان اقامته فرحل الى كوبا واشترى منزلاً واسعاً وجميلاً على مرتفعات منطقة "فينكافيجيا" وهناك راح يستقبل نجوم هوليوود بعد ان تم اقتباس اكثر من رواية من أعماله للسينما. عام 1950، كتب "أبعد من النهر وتحت الشجر" وهي تحكي قصة حب كولونيل عجوز في بعد انساني عميق. ولم يكن احد يعتقد ان همنغواي الذي صار منعزلاً ومنسياً في هافانا في كوبا سيكتب له فصل أخير وعلى قدر من الأهمية في حياته. ففي عام 1952 وحين اعتبر البعض انه انتهى، كتب "الشيخ والبحر" وكان ان فعلت هذه الرواية ما يشبه البرق الساطع في سماء أدبه، فنالت "جائزة بوليتزر" الأميركية عام 1953، وبعدها "جائزة نوبل" للآداب عنها وعن مجمل أعماله عام 1954. وفي ستوكهولم، تسلم همنغواي الجائزة وألقى كلمة وصفت بأنها "اقصر كلمة القاها فائز بالجائزة"!.
وكأن ارنست الطفل أو المراهق اوهمنغواي الشيخ لم يعد لديهم ما يعبرون عن أكثر مما وضعه همنغواي الكاتب في "الشيخ والبحر" وتحديداً في بطله الشيخ الصياد الذي كان يكلم نفسه ويقول: "لو سمعني الناس اتكلم بصوت مرتفع لظنوا انني مجنون. ولكن ما دمت غير مجنون، فلست أبالي بظنونهم.." وذاك العجوز الذي كان بطلاً في شجاعته وعناده واصراره على مصارعة الحياة كان يدرك في نفس الوقت تفاهة الواقع وكان يدرك ايضا ان الحقيقة الكبرى في الحياة تكمن في الموت وان عليه ان يواجهها بشجاعة ايضاً...
صراع مع الموت
وصراع همنغواي مع الموت لم يكن قد بدأ مع مرحلة كتابة لرواية "الشيخ والبحر" بل قبل ذلك بكثير، فهو عندما كتب "لمن تقرع الأجراس"؟ استعان بكلمة مؤثرة من أعمال الشاعر البريطاني جون دون وضعها في افتتاح الرواية جاء فيها: "ما من انسان شبيه بجزيرة كاملة ومنفصلة، كل انسان هو جزء من المحيط، هو جزء من الكل، كل موت يصيب انسانا يميت جزءاً مني لأني مرتبط بالكائن الانساني. لذا عندما تسمع الجرس يقرع لا ترسل احدهم ليسأل: لمن تقرع الأجراس"؟ انها تقرع من أجلك"..
ولم تكن ميتة همنغواي اقل عنفاً من يومياته في سنواته الأخيرة: ففي صباح الثاني من تموز من العام 1961، اطلق النار على نفسه من بندقية صيد شبيهة بتلك التي كان قد اهداه اياها والده وهو في العاشرة. نصف قرن ما بين اقتنائه البندقيتين واذا هو استخدم الأولى في رحلات صيد اعتبرها الأجمل في حياته، فالأخيرة وضعت النقطة النهائية لقصة حياته.
غير ان رحيله لم يضع نقطة النهاية ايضا لأعماله اذ صدر بعد موته عدد كبير من المؤلفات الرائعة وكان أبرزها "باريس عيد" والمخطوطة وضعها في ايامه الأخيرة حين حصلت معه "اعجوبة" ـ حسب قوله ـ يوم وصلته حقيبة من "ريتنر" سبق ان اضاعها خلال الحرب العالمية الثانية، فتم العثور عليها في اقبية الفندق الذي كان قد نزل فيه، بين الأغراض الضائعة للزبائن القدامى. ولكن حين يكون الزبون يدعى ارنست همنغواي فان الحقيبة تصير كنزاً ثميناً، وحين وصلته وصفها بالتالي: "كانت بؤرة ذكريات هائلة" ومنها طلع كتاب "باريس عيد" وغيرها من المؤلفات من وحيها.
ولم تنصف الصحافة همنغواي سوى بعد رحيله، فقد كتب بعض الباحثين سيرته بأكثر من قلم وبأكثر من رؤية مختلفة، غير انها اجمعت كلها على انه وراء قناع الملاكم الملتحي والعنيف أو قناع الصياد الشجاع والشرس احيانا او قناع المقاتل في الحربين العالميتين، كان هناك رجل مفرط الاحساس يختبئ وراء كل هذه الأقنعة ليبرهن للعالم ولنفسه رجوليته التي حجبتها امه مؤقتاً في صغره بمظهر الدمية الجميلة الأمر الذي شكل عقدة في حياته وجعله يعجز عن مسامحتها حتى يومه الأخير، واذا رحيل همنغواي قد رأى فيه البعض ضعفا او خيانة للحياة، فهو في صراع "شيخه" مع البحر وضع ملحمة انسانية لا مثيل لها في تصويره لكفاح الانسان على الأرض وصراعه الكبير مع الحياة عبر صورة مشهدية تحمل جماليات لا توصف ورموزاً هائلة جعلت منها اسطورة من أساطير الأدب العالمي.
وتصادف هذا العام الذكرى الستون لرحيله ويتذكر الأميركيون كما كل قرائه في العالم مسيرة هذا الرجل الذي كتب من ألم وكتب عن أبطال وشخصيات يتحمّلون المصاعب والآلام في تجارب حياتية قاسية دوّنها في روايات خالدة.
كيف عاش همنغواي؟ ومن أين ولد أبطاله؟ لماذا انتحر بعد ان كان طوال حياته يلوم والده على انتحاره؟ كيف شغل هذا الكاتب النجم الصحافة الأميركية والعالمية في يومياته؟ وكيف طغت صورته المحببة على غلافات المجلات ليكسب شعبية اضافية بجمالية اطلالته المغايرة: اللحية البيضاء الطويلة وقبعات الصيد والسمرة التي كان يكتسبها من رحلاته ومغامراته في الطبيعة؟ وأجراس همنغواي التي قرعها في حياته لم تسكت، وبعد رحيله وكان يحتفظ بمخطوطات كثيرة، بدأ نشرها تباعاً وما بين 1964 و1999 قرأ العالم من أعمال همنغواي: "باريس عيد" و"جزر على وشك الانجراف"، "ومغامرات نيك آدامز" و"حديقة عدن" و"الساخن والبارد" و"الحقيقة على ضوء الفجر"... وكأن همنغواي لم يرحل، وكأنه اختبأ من ظلم الحياة وقسوة المرض وراح يرسل من مكانه الخفي أوراقه تباعاً، تلك الأوراق المكتوبة بالدم والدمع وليس أقل. فالروائي همنغواي وإن أبصر النور وسط عائلة ميسورة ومن والدين مثقفين دعماه للوصول الى ما هو عليه، إلا انه عرف في كل فصول حياته المآسي والصعاب والآلام الجسدية والنفسية. لم يكتب همنغواي سوى الصعب والدامي ولم يختر من تجاربه سوى الشديد الألم ليقول احساسه بالحياة. لكنه من ناحية ثانية، عرف كيف يستفيد من عذاباته وكيف يوظفه ايجاباً، فهو كتب ذات يوم: "أفضل ما يمكن ان يحصل لكاتب هو ان تكون طفولته على شيء من التعاسة، وكلما ازداد البؤس والحزن والفقر والقلق والألم، ظهرت الى العلم موهبته في التعبير عن كل ما يختلج في الروح وكل ما يطل من الذاكرة".
لم تكن ولادة ارنست الصغير عادية، فذاك المولود الجميل الذي أبصر النور في 21 تموز من العام 1899 في منطقة أواك بارك في شيكاغو أضفى سعادة على العائلة التي استقبلت الابن البكر بحفاوة وسيكون له بعد سنوات أربع شقيقات وأخ صغير: الأم وتدعى غرايس هال مطربة أوبرالية كانت تشارك في حفلات محلية في المنطقة ووالده كلارنس همنغواي كان طبيب أسنان، غير انه كان يهوى الصيد والرحلات في الطبيعة، فبدأ ابنه ارنست يرافقه قبل العاشرة، واشترى له بندقية في العاشرة. أما هذه الرحلات فالحديث عنها لأنها ستكون ذات صلة وثيقة بكل ما سيكتبه همنغواي، وفي الطبيعة ستتفتح أفكاره المذهلة، وسيكتب ويعيش فترات طويلة من حياته في الغابات أو قرب شاطئ البحر، وسيكتب من وحي رحلات الصيد البحرية المذهلة التي سيختبرها بقوة وشغف في رائعته "الشيخ والبحر" والتي ستكون الحافز الأول والمباشر لجعل لجنة نوبل تكرّمه بجائزة "نوبل للآداب" عام 1954.
محرر
منذ سن المراهقة حلم ارنست بأن يصبح كاتباً فلم يدخل الجامعة بحجة ان سنوات طويلة للدراسة ستفصله عن التفرغ للكتابة، فعمل منذ العام 1917 وكان في الثامنة عشرة محرراً في "كانساس سيتي ستار" وفي نفس الوقت سحرته فكرة ان ينجح في الحياة العسكرية وكان ذلك بأثر من دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب العالمية الأولى وفي مذكرات لاحقة يتذكر ارنست هذه المرحلة ويشرحها ويحللها بنفسه معتبراً انه كان بصدد البحث عن مهنة معينة "خاصة بالرجال" ليثبت رجوليته ونضجه بسبب سوء تربية والدته له التي كانت ترغب في تحويله الى "فتاة دمية" في طفولته بسبب جمال وجهه، فكانت تترك شعره يطول كالفتيات وهذا واضح في صوره من تلك المرحلة وتجعله يرتدي الفساتين وتقول لصديقاتها وأقربائها: "ألم يكن من الأفضل لو ولد بنتاً؟" هذا الأمر استمر حتى بلغ سناً تجعله يرفض ويثور، وهو كتب عن والدته وعن تلك المرحلة معتبراً انها كانت امرأة هستيرية وأنانية.
غير ان رغبته في دخول الجيش لم تتحقق بسبب رسوبه في الفحص الطبي فهو كان يعاني قصر النظر بشدة وكان يرفض وضع نظارتين، وهذا السبب وكتبه في مذكراته أيضاً أي قصر النظر جعله أيضاً يتخلى عن الدراسة الجامعية، فهو كان عاجزاً عن متابعة الدروس والشرح على اللوح البعيد، فاكتفى بالكتاب والمطالعة عن قرب. لكن كل هذا لم يمنعه من الالتحاق بكتيبة سيارات الإسعاف في الجيش وبعد ثلاثة أسابيع من العمل أصيب بجروح اثر انفجار قنبلة بالقرب منه في ايطاليا وكان ذلك في العام 1918 فقضى ستة أشهر في المستشفى ومع عودته الى بلدته استُقبل كالأبطال خاصة بعد ان عرف الجميع انه أصيب بسبب إصراره على إنقاذ جرحى في الحرب. لكن رجوعه لم يلبث ان جعله يدخل مجدداً في أحزان كبيرة حين مرض والده ثم انتحر، فالقى كل اللوم على والدته وحملها مسؤولية انتحار والده.
القطيعة
وهنا بدأت القطيعة مع مرحلة الطفولة والمراهقة في حياة همنغواي حيث قرر الابتعاد والبدء بحياة جديدة بدأت معها الكتابة.
باريس والكتابة: "الشمس تشرق أيضاً. ومع وصوله الى باريس عام 1920 "، وكان همنغواي قد تزوج بامرأة تدعى هادلي ريتشاردسون وكانت تكبره بأكثر من ثمانية أعوام، فانطلق من شقتهما الصغيرة في العاصمة الفرنسية الى اكتشاف عالم الأدب والثقافة، وفي باريس التقى جيرترود ستاين وإزرا باوند وسكوت فيتزجيرالد وشرود أندرسون وغيرهم من الكتّاب الأميركيين المقيمين في فرنسا، فصار جزءاً من مجموعة المغتربين في العشرينيات التي أسستها جيرترود ستاين وعرفت باسم "الجيل الضائع"، ولقي من بعضهم المساعدة لنشر أول أعماله وكانت المجموعة القصصية "في زمننا" التي نشرت في أميركا عام 1925 وبعدها رائعته "الشمس تسطع أيضاً" عام 1926 وهي الرواية التي جعلته يبرز كواحدٍ من الروائيين المتميزين الشباب مع انها وحسب رأي النقّاد امتازت ببساطة متناهية وبالخلو من التعقيد، وجاءت بأحداثها لتبدو مفرطة في الواقعية وقد عالج فيها موضوع الاحتفالات السنوية التي تجري سنوياً في اسبانيا في مجال مصارعة الثيران، وقد حلل نقطة دقيقة وحساسة في الموضوع وهي انه لا بد دائماً من قتيل في هذه المصارعة: الثور أم المصارع؟
وقد اعتبر عدد كبير من النقّاد ان الرواية جاءت في غاية الحساسية بسبب شغف همنغواي بفكرة الموت في تلك المرحلة كما شغفه بفكرة اثبات رجوليته عبر بطليه اللذين يتحادثان عبر كل فصول الرواية حول الحب والمرأة والجسد والجنس، فصنّف الكتاب أيضاً في خانة "الأدب البعيد عن الأخلاقيات" وذهب البعض في اتجاه معاكس الى اعتباره "أبرز رواية تصوّر حياة جيل الشباب الضائع في تلك المرحلة".
"وداعاً أيها السلاح"
نجاح روايته الأولى أعطاه دعماً معنوياً للكتابة من جديد، فاستمرت كتبه بالتألق خاصة مجموعات القصص القصيرة التي أطلقها في السنوات 1927 و1928 ووضع فيها تقنية السرد الصحافية الى حد ما واتصفت بالوصف المباشر، الى ان ظهرت رواية "وداعاً أيها السلاح" واعتبرت من أفضل الروايات التي كتبت في تلك المرحلة ضد الحرب.
وتدور أحداثها حول بطله الشاب فريديريك هنري الذي أدرك من خلال الحب حماقة المشاركة بالحرب وما ينتج عنها من دمار نفسي وخارجي محاولاً تحقيق سلامه الداخلي خارج الخضوع التقليدي للظروف والواقع.
واعتبرت "وداعاً أيها السلاح" من أبرز الأعمال التي سمحت بالمرور الى الرواية المعاصرة عبر كل ما قدمته من أفكار حول التأثير السلبي والعالمي للحروب والشرور الذي لا مفر لنا منه جميعنا وكيف انه هناك دائماً أحدهم ليدفع ثمن الشجاعة والحب والاحساس الإنساني العميق.
وتماماً كما جذبت الحرب العالمية الأولى همنغواي لأن ينخرط في صفوف المقاتلين، حدث كذلك حين قرر العمل كمراسل حرب في اسبانيا خلال الحرب الأهلية فيها وكذلك على جبهة الحرب العالمية الثانية، حيث كان يراسل مجلات عديدة. وثمة موضوع جديد بدأ يشغله في تلك الآونة وقد وصفه في مجمل أعماله وهو حول كيفية الحفاظ على موهبته ككاتب في مواجهة كل تهديدات الحياة في الحروب كذلك التهديدات من نوع آخر والتي تولدها الحرب أيضاً مثل ضياع القيم والثوابت في المجتمعات وأيضاً السعي وراء المال والنجاح والشهرة كتعويض عن نواقص كثيرة في الأزمات. كل هذا وضعه في روايته التالية وكان عنوانها: "ثلوج كليمانجارو" التي نشرها عام 1936، ومن بعدها رواية "لمن تُقرع الأجراس" عام 1940 وقد وضع فيها كل هذه الأفكار التي تبنّاها وتبدو فيها أجواء الريف الاسباني وأهله الذين وصفهم وصفاً دقيقاً ومؤثراً في ذلك الكتاب.
الشيخ والبحر
من "لمن تُقرع الأجراس" الى "الشيخ والبحر" ولكن ما بين روايته "لمن تُقرع الأجراس" وأجوائها الريفية وروايته "الشيخ والبحر" 1952 التي تعتبر ملحمة بحرية بامتياز أو بتعبير آخر من الأعمال الأدبية التي وصفت عالم البحر ومجّدته عبر غوص في أعماقه وأسراره الغامضة، ثمة تغيير حدث في حياة همنغواي الذين غاص شيئاً فشيئاً في حياة بوهيمية، وصار البحر الواسع مشهداً مؤثراً في يومياته حيث كان يمضي نهاراته في هواية الصيد التي لم تكن فقط محدودة في معانيها وأهدافها.
فلم يكن الصيد في حياة همنغواي لمجرد الحصول على نتيجة وافرة من أسماك ولا لمتعة الهواية لتمضية الوقت، بل كانت في رمزيتها ذاك الغوص اليومي والمتكرر في مجاهل البحار والحياة وكأنه يبحث عن مجهول في ذاك المشهد البحري الهائل الذي صوّره عبر شخصيته الروائية، ذاك الشيخ العجوز في صراعه مع البحر. فقد صورت رواية "الشيخ والبحر" البعد الآخر للقوة الجسدية والنفسية للإنسان في صراعه للبقاء عبر شخصية العجوز الذي يتحدى قوة الطبيعة في صراعه أيضاً مع السمكة الضخمة التي اصطادها ذات يوم. غير ان صراعه يتسم بالوحدة والعزلة حيث عاشهما وحيداً، لا عون له في مواجهة شرسة بقوة حب البقاء. وبطله الشيخ ويدعى سانتياغو عاش يأساً كبيراً بعد ان أمضى شهوراً عدة يصطاد من دون ان يحصل على نتيجة، وتحديداً 84 يوماً، وفي اليوم الخامس والثمانين، اصطاد سمكة ضخمة بقي يصارعها لمدة يومين ليلاً ونهاراً، متحدياً التعب والجوع وعدم النوم والألم الناتج عن الجروح التي تعرض لها في معركته الأقرب الى الأسطورية، ليواجه في مرحلة ثانية وبعد ان اصطاد سمكته، أسماك القرش المفترسة التي هاجمته في طريق عودته الى منزله البحري على الشاطئ، فقد عاد أخيراً لكنه عاد مع ما بقي من صيده: حسكة ورأس سمكة مهمش.
"الشيخ والبحر" اعتبرها العالم بمثابة الملحمة الإنسانية التي رمزت بقوة وجمالية فائقتين الى حياة الإنسان وسعيه في مصارعة القوى المحيطة به بإرادة صلبة وشجاعة لا مثيل لها ليصل أخيراً خاوي اليدين في مواجهة الواقع المرير. ولقد أجمع النقّاد أيضاً على ان هذه الرواية البحرية بامتياز هي صورة طبق الأصل عن واقع حياة الكاتب في الفصل الأخير من حياته حين عاش لفترة طويلة ملازماً للبحر، وليس سانتياغو سوى صورة عنه بعد ان عاش حياته يصارع ويتحدى الأقدار حتى وصل الى مرحلة فقد فيها قواه الجسدية والروحية في آنٍ. لكن روايته هذه لم تكن مقفلة على اليأس بل وضعها في إطار الأمل عبر شخصية الولد الصغير والصديق للعجوز والمعجب به التي استمر يرافقه في رحلاته وكأنه صورة عن الأمل والحياة المتجددة، كما ان الشيخ وبعد تجربته هذه، عاود النزول بمركبه الى البحر للصيد ولاختبار المجهول ثانية. هذا الصراع الرائع للإنسانية الذي صوره همنغواي في "الشيخ والبحر" كرسّته "جائزة نوبل للآداب" واحداً من الروائع الأدبية الخالدة.
ولقد لقّب همنغواي بعدد من الألقاب كان أبرزها "بابا" أي الأب الروحي والفعلي للرواية الحديثة والمعاصرة التي ستعرف منذ تلك المرحلة، أي منتصف الخمسينيات من القرن العشرين،التمرد والانطلاق والتجدد. واذا غلبت النظرة السوداوية للعالم في كتاباته الأولى فهو تفاعل وتجدد في مراحل متفرقة من حياته الأدبية وعمل عبر رواياته الأخيرة على تمجيد القوة النفسية وقوة العقل لدى الانسان، فصور هذه القوة في تحدياتها لقوى الطبيعة في صراعات متنوعة. ولقد عكست مؤلفات همنغواي أيضاً تجاربه الشخصية، فهو عاش وشارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية كما الحرب الأهلية في اسبانيا، فأصيب في المعارك وراقب من كثب آلام الآخرين فكتب عن أبطال يتحملون المصاعب والآلام من دون شكوى وتعكس هذه الشخصيات طبيعته الشخصية. أما أسلوب همنغواي الذي وصف معظم النقاد بالسهل والواضح والعفوي وقد كان متقناً نتيجة ممارسته الطويلة للكتابة الصحافية حيث أفادته كتابة التقارير وحتى السياسي منها في تقصي الحقائق من حول الأحداث التي يعيشها، ولعل أفضل وصف لأسلوبه في الكتابة هو ما وضعه بنفسه، فقد صرح ذات يوم بأنه يهيئ أغلب أعماله في ذهنه أولاً.. "ولا أبدأ الكتابة قبل ان تكون أفكاري قد نظمت جيداً. وكثيراً ما أقوم بتلاوة نصوص من أي حوار اكتبه وبالطريقة التي ستكون عليه عند كتابتها، فأنا أؤمن بأن الأذن هي أفضل وأحسن مراقب أو ناقد.. ثم لا أكتب أي جملة على الورق قبل ان اتيقن بأن الطريقة التي سأعبر بها ستكون مفهومة وواضحة تمام الوضوح للجميع..".
.. الى العزلة في هافانا
ثمة من كتب سيرة همنغواي ولخص التغيير في سنواته الأخيرة بالتالي: "بعد الحرب، لم يعد همنغواي كما كان" بدأت تنقصه الحركة كذلك الحيوية والنشاط، وبطل الحروب صار اقل من انسان عادي.."
في تلك المرحلة تغيرت شخصية الكاتب وحسب كل المقربين منه: "ثمة ما تبدل في شخصيته" وقد اعتبر بعض المحللين ان الأمر يعود الى وراثة في العائلة، فوالده عاش اضطرابات في شخصيته بعد سن معينة وانتحر، كذلك انتحرت اثنتان من شقيقات الكاتب، وستنتحر عام 1996 حفيدته الممثلة الهوليودية مارغوهمنغواي.
وما لبث ان اصبح همنغواي عنيفاً ومنعزلاً وذهب الى اقصى حدود الخيانة ان مع نسائه وان مع اصدقائه، فقد وصف أكثر من صديق "بالخائن".
أما الذي لم يعرفه عنه هؤلاء الأصدقاء الذين هجروه هو انه كان على طريق خيانة نفسه ايضاً، وكان ان اعتقد بأنه سيتغير مع تبديل مكان اقامته فرحل الى كوبا واشترى منزلاً واسعاً وجميلاً على مرتفعات منطقة "فينكافيجيا" وهناك راح يستقبل نجوم هوليوود بعد ان تم اقتباس اكثر من رواية من أعماله للسينما. عام 1950، كتب "أبعد من النهر وتحت الشجر" وهي تحكي قصة حب كولونيل عجوز في بعد انساني عميق. ولم يكن احد يعتقد ان همنغواي الذي صار منعزلاً ومنسياً في هافانا في كوبا سيكتب له فصل أخير وعلى قدر من الأهمية في حياته. ففي عام 1952 وحين اعتبر البعض انه انتهى، كتب "الشيخ والبحر" وكان ان فعلت هذه الرواية ما يشبه البرق الساطع في سماء أدبه، فنالت "جائزة بوليتزر" الأميركية عام 1953، وبعدها "جائزة نوبل" للآداب عنها وعن مجمل أعماله عام 1954. وفي ستوكهولم، تسلم همنغواي الجائزة وألقى كلمة وصفت بأنها "اقصر كلمة القاها فائز بالجائزة"!.
وكأن ارنست الطفل أو المراهق اوهمنغواي الشيخ لم يعد لديهم ما يعبرون عن أكثر مما وضعه همنغواي الكاتب في "الشيخ والبحر" وتحديداً في بطله الشيخ الصياد الذي كان يكلم نفسه ويقول: "لو سمعني الناس اتكلم بصوت مرتفع لظنوا انني مجنون. ولكن ما دمت غير مجنون، فلست أبالي بظنونهم.." وذاك العجوز الذي كان بطلاً في شجاعته وعناده واصراره على مصارعة الحياة كان يدرك في نفس الوقت تفاهة الواقع وكان يدرك ايضا ان الحقيقة الكبرى في الحياة تكمن في الموت وان عليه ان يواجهها بشجاعة ايضاً...
صراع مع الموت
وصراع همنغواي مع الموت لم يكن قد بدأ مع مرحلة كتابة لرواية "الشيخ والبحر" بل قبل ذلك بكثير، فهو عندما كتب "لمن تقرع الأجراس"؟ استعان بكلمة مؤثرة من أعمال الشاعر البريطاني جون دون وضعها في افتتاح الرواية جاء فيها: "ما من انسان شبيه بجزيرة كاملة ومنفصلة، كل انسان هو جزء من المحيط، هو جزء من الكل، كل موت يصيب انسانا يميت جزءاً مني لأني مرتبط بالكائن الانساني. لذا عندما تسمع الجرس يقرع لا ترسل احدهم ليسأل: لمن تقرع الأجراس"؟ انها تقرع من أجلك"..
ولم تكن ميتة همنغواي اقل عنفاً من يومياته في سنواته الأخيرة: ففي صباح الثاني من تموز من العام 1961، اطلق النار على نفسه من بندقية صيد شبيهة بتلك التي كان قد اهداه اياها والده وهو في العاشرة. نصف قرن ما بين اقتنائه البندقيتين واذا هو استخدم الأولى في رحلات صيد اعتبرها الأجمل في حياته، فالأخيرة وضعت النقطة النهائية لقصة حياته.
غير ان رحيله لم يضع نقطة النهاية ايضا لأعماله اذ صدر بعد موته عدد كبير من المؤلفات الرائعة وكان أبرزها "باريس عيد" والمخطوطة وضعها في ايامه الأخيرة حين حصلت معه "اعجوبة" ـ حسب قوله ـ يوم وصلته حقيبة من "ريتنر" سبق ان اضاعها خلال الحرب العالمية الثانية، فتم العثور عليها في اقبية الفندق الذي كان قد نزل فيه، بين الأغراض الضائعة للزبائن القدامى. ولكن حين يكون الزبون يدعى ارنست همنغواي فان الحقيبة تصير كنزاً ثميناً، وحين وصلته وصفها بالتالي: "كانت بؤرة ذكريات هائلة" ومنها طلع كتاب "باريس عيد" وغيرها من المؤلفات من وحيها.
ولم تنصف الصحافة همنغواي سوى بعد رحيله، فقد كتب بعض الباحثين سيرته بأكثر من قلم وبأكثر من رؤية مختلفة، غير انها اجمعت كلها على انه وراء قناع الملاكم الملتحي والعنيف أو قناع الصياد الشجاع والشرس احيانا او قناع المقاتل في الحربين العالميتين، كان هناك رجل مفرط الاحساس يختبئ وراء كل هذه الأقنعة ليبرهن للعالم ولنفسه رجوليته التي حجبتها امه مؤقتاً في صغره بمظهر الدمية الجميلة الأمر الذي شكل عقدة في حياته وجعله يعجز عن مسامحتها حتى يومه الأخير، واذا رحيل همنغواي قد رأى فيه البعض ضعفا او خيانة للحياة، فهو في صراع "شيخه" مع البحر وضع ملحمة انسانية لا مثيل لها في تصويره لكفاح الانسان على الأرض وصراعه الكبير مع الحياة عبر صورة مشهدية تحمل جماليات لا توصف ورموزاً هائلة جعلت منها اسطورة من أساطير الأدب العالمي.
اخر الاخبار